المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة
- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا
- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها
- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار
- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس
- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال
- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ
- لماذا يتزوجون في الأردن؟!
ما قبل الإبحار
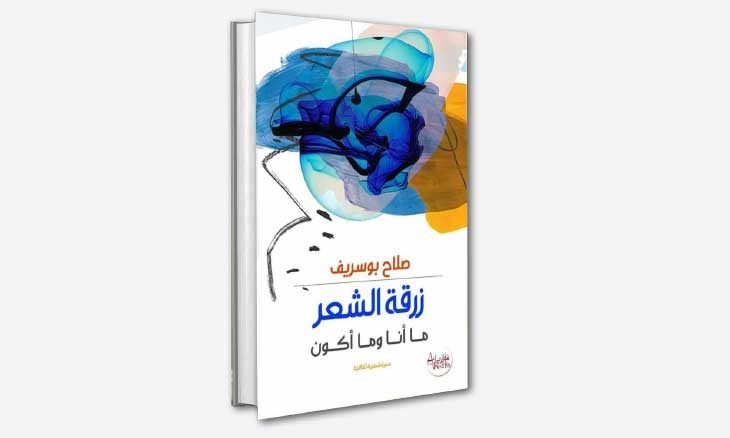
القدس العربي-صلاح بوسريف
بدافع غامض، لا أعرف ما يكون، رأيت أن أكتب هذا الجزء من سيرتي الشعرية. لا بمعنى السيرة التي فيها أتحدث عن حياتي، أو عن بعض حياتي، كما يفعل الشعراء والكتّاب، وغيرهم ممن أتيح لهم أن يكونوا في قلب الحدث الثقافي، أو الفني، بل بمعنى السيرة النظرية ـ الجمالية، التي يكون فيها الشعر هو موضوع الذات، أو تكون فيها الذات، بمعناها الشعري الجمالي. أعني الذات الكاتبة، التي وجدت نفسها في ماء، إما أن تتعلم السباحة فيه لتنجو من الغرق، وإما أن يستغرقها الماء فتطفو على سطحه، مثل قشة تدفعها الريح في كل اتجاه، بدون إرادة أو رغبة منها.
بقدر ما كان الماء سببا في غرقي، بقدر ما كان سببا في معرفتي بالسباحة، وخوض ما واجهني به من أمواج، وما علا منها وارتفع، كان أكثر مما انحدر ماؤه وهوّن عليّ بعض أشجاني. فالشعر وحده مجرة، لا يمكن إدراك شساعتها، ولا ما تحفل به من مشكلات وتشابكات، لأنه معرفيا، يفرض على من يخوض ماءه أن يعرف طباع الرياح والسحب والعواصف والأمواج، ويعرف متى يصارع تياراته، ومتى يترك الماء يأخذه حيث شاء، قبل أن يقود الماء في ما يرغب فيه من طرق ومسالك، بل من مضائق، لأن كل ما يبدو في الشعر مسلكا، فهو ليس سوى مقدمة لمضيق، أو مضائق هي ما به يبني الشاعر ثقافته أو «علمه» بالشعر، أو بـ«صنائعه» لا بـ«صناعته» وفق تعبير القدماء.
لا معرفة بالشعر بدون معرفة بصنائعه، أو بما يحتمله من آلة، حتى ونحن نثور على هذه الصنائع والآلات، فلا ثورة بدون معرفة أسباب ودوافع هذه الثورة، لا أن نثور فقط، لنكون ثوريين بدون أن نعرف لماذا نثور، وما سبب ثورتنا، وما الذي نذهب إليه كبديل عن هذا الذي نثور عليه، فكرا كان، أو رؤية وأفقا. حين أكد الأصمعي على المعرفة الشعرية كشرط لا بد منه للشاعر ليصير شاعرا، فهو لم يجعل المعرفة سابقة على الشعر، بل جعلها الإطار الذي يتيح للشاعر أن يعرف طبيعة الأرض، أو الماء الذي فيه سيزاول السباحة، حتى لا يكون الماء بلون الغرق.
يقول الأصمعي «لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا، حتى يروي أشعار العرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا على قوله، ولنحو يصلح به لسانه وليقيم إعرابه، والنسب وأيام الناس ليستعين على ذلك بمعرفة المناقب والمثالب، وذكرها بمدح أو ذم» (عن كتاب العمدة 1. 132). ما يعني أن الشعر هو ثقافة ومعرفة وجمال، وأن الماضين، رغم أن منهم من أكد على البديهة والارتجال، مثل الجاحظ، كانوا لا يتنازلون عن شرط المعرفة، لأن الشعر نسج، وحبك، ومعرفة بحياكة النص، أو الخطاب، كما في القصيدة التي كانت تستحكم الشفاهة والإنشاد في بنياتها ومكوناتها، بل إن الجاحظ، ذهب إلى حد تشبيه صناعة الشعر، أي ما افترضه معرفة ضرورية بالشعر، قبل الذهاب إليه، بـ«علم الطب» فهو «لا يحسن منه شيئا أو يكون من الحذاق المتطببين، فإنه إذا أحسن من شيء ولم يبلغ فيه المبالغ، هلك وأهلك أهله، وكذلك العلم بصناعة الكلام» (البيان والتبيين 3. 337).
تشعبت المعارف والعلوم، اليوم، وتشابكت، وأصبح الشعر غير ما كان عليه زمن الماضين من أسلافنا الشعراء والنقاد. لم يعد ممكنا أن ندخل الماء بالسباحة فقط، بل إن مساحات الماء نفسه اتسعت، وأفق الزرقة لم يعد متاحا بما كانت عليه الرؤية من قبل. غزو البحار والمحيطات يقتضي أن نخوض الماء بغير وسائل الماضين، وما كان يسعفهم من علوم ومعارف، أو من آلات وصنائع. الشعر، اليوم، سباحة في الغرق نفسه، بمواجهة اللج، بل بالسير عكس الماء وعكس الريح. المعرفة تبقى، دائما، هي «آلة» الإبحار وخوض الماء مهما كانت درجة الخطر فيه، أو ما نستشعره فيه من أهوال ومثالب.
بهذا الوعي عشت سيرتي الشعرية، وفي هذا المفترق من حياتي، ربما وأنا في عقدي السادس، رأيت أن أدلي بشهادتي في كيف دخلتُ الشعر، وكيف خضتُ فيه الكتابة بشغف وبمسؤولية، وما جرني إليه من بحث وتعمق، لم يكن ممكنا أن أبدأهما من الحاضر، أو أكتفي بزمني، بل وجدت الماضي يدعوني إلى فتنه بتعبير الجاحظ، وإلى أن أعرف البدايات قبل أن أنظر إلى ما هو آت. لم يكن ممكنا أن أؤسس لمعرفتي بالشعر، بدون أن أذهب إلى الشعر نفسه، في متونه، وإلى النقد المحايث له، وإلى التاريخ، وإلى السياقات الثقافية التي كانت ضمن ما تأسست عليه «القصيدة» كما وصلتنا، أو وصلنا إليها. بقدر ما أفادني الحديثون بما فتحوه لي من طرق في ما كتبوه عن الشعر من دراسات وأبحاث، بقدر ما دفعوني إلى العودة إلى «الأصول» وإلى بعض ما سأجد فيه ما كان ضوءا، قادني إلى ما خضته من طرق. لم أدخل الشعر من حاضره، بل جئت إليه من ماضيه، من تعلمي السباحة في قيعانه، في ما تبقى منه من طوفان بعيد، جرف الأرض بكل ما فيها، لتنهض الأرض من عشبها وطينها، بما بقي في هوائها من ريح. الشعر، بهذا المعنى، كان جرحا، ووجودا يضاهي الوجود. كان جمرة، كلما عام عليها رمادها، من رمادها خرجت، وهجا آخر، جديدا، هو ما أضفى على الوجود خميرته، التي منها تخلّق وانبثق. لم يكن ممكنا أن أصل إلى الحديث وإلى الحداثة، بدون أن أكون جئت من هذا الماضي الذي بدأ عند العرب، كما عند غيرهم من الأمم والشعوب، شعرا. أن أنتصر إلى الحداثة، وإلى حداثة الكتابة، بل إلى الشعر لا «القصيدة» وإلى العمل الشعري، تحديدا، فهذا معناه أنني أنتصر لماضي الإبداع، لأوله، لمن فتحوا المضائق الأولى، أو خاضوها بكل مشكلاتها، وأن أبحث لنفسي عن طريق حتى لا أكون مثل متعقب الآثار، لا تهمه الطريق، بقدر ما يهمه من عبرها، وهو بذلك لن يكون سوى تابع، يسير في طرق الآخرين، لأنه لا طريق له، بل وجد بدون طريق. أعني أنه الصدى، لا الزرقة نفسها.
في هذه السيرة الشعرية ـ الجمالية، لم يكن يهمني الأشخاص، بل الشعر، المحترف الذي كرست له أربعة عقود من عمري، قراءة، بحثا، إنصاتا وتأملا. جمعت بين الشعر والنظر فيه، لم أكن ناقدا، ولم أرغب في أن أكون ناقدا، ما كتبته، مما اعتبره البعض نقدا، كان يخصني في تصوري للشعر، كان سؤالا عن السر الثاوي وراء النص، ووراء هذا السحر الذي يأخذ القارئ ويسجنه في مائه. من أين يأتي، ما الجهة التي منها يأتي، بأي منظور، وبأي معنى، وكيف يكون مؤثرا، وما الطرق والأساليب التي تجعل لغته تكون خرقا للغة ذاتها، لغة في قلب اللغة، هي وليست هي في الآن ذاته؟ كان هذا القلق الذي ما زال يعتريني، هو ما رمى بي في قلب السؤال، في ماء الشعر، في زرقته، في أراضيه التي بدا أنني عثرت فيها على ما يليق بي من حقول وبساتين، شرعت أرعى فيها النجوم والزهور والأقمار، وأملأ أحواضها بالماء والموج والهواء. لم أكتف بالأرض في بذر زروع بساتيني وأحواضي، بل نظرت في ما فوقي من زرقة، باعتبارها امتدادا للأرض التي فيها أرعى وعولي، رغم توحشها وما في طبيعتها من سر وشراسة، وما ترغب فيه من خلاء وعشب وهواء وماء.
الشاعر هو هذا الجرح الكبير، هذه الكلمة التي يلقيها في الحقل لتصير خميرة لحقول أخرى تنتظر من يخوضها بشغف واحتراق، وبوعي ومسؤولية، مثل بروميثيوس الذي نذر روحه لتحرير الآخرين، من قيد الإله، الذي استبد بالنار له وحده، دون غيره. من هذا الجرح الكبير جئت، وهو ما رأيت أن أرعاه بكل ما رافق سيرتي من آلام، وما اعتراها من إبادة وقتل، لولاهما، ما كنت لأكون، أو ما أنا، في ما أبدو عليه من وجود بالشعر، لا بغيره.
٭ شاعر مغربي


