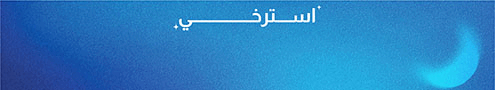المواضيع الأكثر قراءة
- إستراتيجية نتنياهو انعدام الرحمة
- الأردن ينفذ إجلاءً بريًا لـ34 مريضًا من غزة برفقة 97 مرافقًا الأربعاء
- الخارجية تدين هجوما إرهابيا استهدف كنيسة في الكونغو
- دبلوماسية ملكية تصنع التحول بالمواقف الدولية تجاه فلسطين
- انحسار الموجة الحارة وأجواء معتدلة الأربعاء
- فرنسا ستلقي 40 طنا من المساعدات فوق غزة اعتبارا من الجمعة
- 5 قتلى على الأقل أحدهم شرطي بإطلاق نار في نيويورك
- المفوضية الأرووبية تعلق التعاون العلمي مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة
- الإمارات تمنح السفير الأردني وسام الاستقلال
- حصيلة الشهداء في قطاع غزة تتجاوز 60 ألفاً
رواية «يوميات مريم» لصفاء الحطاب/ قراءة سردية-تأويلية
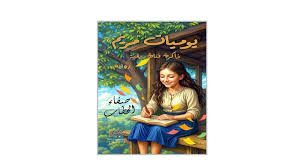
الدستور-أ. د. سلطان المعاني
ينفتح العنوان يوميات مريم: ذاكرة فتاة ريفية على أفق دلالي مزدوج، يجمع بين التوثيق الذاتي والتخييل التأويلي، ويُمهّد منذ اللحظة الأولى لمسار سردي يمثل الحياة اليومية، ويعيد صياغتها من خلال ذاكرة ذاتية مشبعة بالحنين والتساؤل. فلفظة «يوميات» توحي بفعل التسجيل، بينما تأتي عبارة «ذاكرة فتاة ريفية» لتمنح البُعد الزمني والطبقي والمكاني ثقله الرمزي، حيث تقاطعات الذات مع الجماعة، والخاص مع الاجتماعي، والذاكرة مع الكتابة بوصفها فعل مقاومة للاندثار. أما الغلاف، فيؤسس منذ النظرة الأولى لعالم داخلي تتداخل فيه عناصر الطبيعة والكتابة والطفولة؛ الطفلة الجالسة في حضن الريف، الشجرة التي تُحيل إلى الجذور، وملامح السكون التي تقابلها يقظة داخلية، تشكّل جميعها عتبة نصية تشي بأن ما سيُروى سرد عن ماضٍ غابر، وعن لحظة وجودية تعاش داخل النص عبر الحنين واللغة.
تنتمي الرواية إلى أدب اليافعين، ولعلها تخاطب فني مساحة أوسع فئة عمرية تقع بين اليافعين المتقدمين والراشدين، أولئك الذين يملكون حساسية وجدانية ومعرفية تتيح لهم الدخول في النص بوصفه تجربة. تبتعد الرواية عن السرد المباشر أو عن الحبكات الدرامية التقليدية، لتستثمر في التفاصيل، الإيقاع الداخلي، وارتجافات الشعور، ما يجعلها أقرب إلى القارئ الذي يرى في الطفولة مشروع وعي متجدد.
تتبنى الرواية أسلوب سرد يمزج بين الصوت الداخلي للطفلة وبين التكوين الناضج للساردة، فتُروى الأحداث من زاوية التبئير الداخلي، غير أن هذا التبئير يخضع لتحولات ناعمة تكشف عن وعي لاحق يعيد ترتيب التجربة ويُضيء ما لم يكن ممكنًا التعبير عنه آنذاك. لم يأت الصوت بريئًا ولا مطلق الوعي، فقد جاء متوتراً بين لحظتين زمنيتين: لحظة العيش ولحظة الكتابة، فاللغة في هذا السياق تأتي مصفّاة، مشبعة بالإيحاء، تتجنّب المباشرة أو البلاغة المنمقة، وتغدو وسيلة تَلَمُّسٍ لما هو غير قابل للقول، حيث تسير بمحاذاة الصمت، وتحاول أن تصوغ بالأثر ما عجزت اللحظة عن قوله.
أما المنهج النقدي الأنسب لتحليل هذه الرواية فهو المنهج السردي التأويلي، الذي يدمج بين أدوات التحليل البنيوي كما صاغها جيرار جنيت، ومفاهيم الهوية والزمن كما طوّرها بول ريكور، ويتقاطع مع البعد الحواري الباختيني في تعدد الأصوات. هذا المنهج يقوم على تفكيك البنية الظاهرة، ثم يغور في الطبقات العميقة للنص، فيصغي إلى تشظّي الزمن، وتداخل الأصوات، وارتباك الهوية، بوصفها مكوّنات سردية تشكّل مسار التكوين الداخلي لشخصية مريم. ومن المتوقع، في هذه الرواية، أن يُقرأ النص كخط زمني ممتد، وكبنية وعي يُعاد كتابتها من موقع وجودي لاحق، يعيد عبر الحكي فهم ما كان، ويحوّل الذاكرة إلى فضاء تأويلي يعبر الجغرافيا والطبقة والسن ليغدو كتابة للنجاة. وتتقدّم الرواية ضمن نسق سردي متداخل، لا يُفسَّر بمنهج بنيوي صرف، ولا يُحتوى بالكامل ضمن مقولات الهوية والزمن الوجودي، ولكن قراءتها تستدعي منهجًا تركيبيًا يتخذ من السرد بنية تحليل، ومن الهوية مجالًا تأويليًا، ومن الزمن مادة لتفكيك الشعور والموقف. إن المنهج السردي التأويلي هنا، بوصفه مقاربة هجينة تنطلق من تصورات جيرار جنيت حول التبئير، والمفارقات الزمنية، والمدة السردية، وتندمج بمفاهيم بول ريكور حول الهوية السردية والذاكرة، يتيح فهمًا متعدد الطبقات للنص، يرصد البنية ويسبر أغوار الذات وهي تعيد ترتيب نفسها عبر الحكي. ففي مستوى الزمن، تتكشّف بنية الرواية بوصفها نظامًا يقوم على الانقطاع والتداعي، لا على الاتصال والتسلسل؛ فالطفولة تُسرد كما طُبعت في الوجدان، فلا يُعاد بناؤها وفق نظام كرونولوجي، وإنما وفق منطق داخلي يحكمه الأثر لا الحدث. وتتكرّس المفارقة الزمنية عبر استخدام الاسترجاع الزمني، الذي يعود إلى الوراء ليكشف كيف تنشأ الذات عبر نقاط انكسارها، حين يُعاد استحضار لحظة صامتة في فناء المدرسة، أو لحظة انقطاع بين الطفلة وأمها، أو حتى تأمل داخلي في عبور الطريق نحو البيت. هنا، يتفكك الزمن الواقعي لصالح زمن النفس، حيث تتقلّص أو تتمدد اللحظات وفق كثافتها الوجدانية، ما يجعل الرواية تعتد بقياس عدد السنين، ولكن بعدد التصدّعات الشعورية التي خلخلت إحساس الطفلة بالانتماء واليقين.
أما على مستوى الهوية، فإن السرد لا يقدم صورة مكتملة أو مستقرة لمريم، فهو يكشف عن هوية سردية غير متطابقة، تتكوّن من شظايا صوت وصورة وغياب. مريم تُعرّف ذاتها من خلال التوتر بين ما ترويه الآن، وما لم تستطع قوله حينها. وهذا هو جوهر ما يسميه ريكور بـ»الهوية السردية»، حيث لا تكون الذات معطى ثابتًا، وإنما نتاجٌ دائمُ التكوّن عبر الحكي، يتبدّل ويتجدد مع كل استدعاء للذاكرة، فهوية مريم تتأرجح بين الطفلة التي شعرت أنها غريبة في المدرسة، والراشدة التي تفكك تلك الغرابة بالكلمات. هذه الهوية تتجذر في لحظات الشك، وفي قلق الانتماء، وفي تعرّف الذات إلى ذاتها بوصفها سؤالًا مستمرًا. ولا ينفصل هذا التشكل الهوياتي عن الهيئة البنيوية للرواية، حيث الصوت السردي يخضع لتموّجات بين التبئير الداخلي والتبئير الأعلى، فيتماهى مع وعي الطفلة في أغلب النص، لكنه لا يمنع الراوية من التدخل في لحظات تأملية تكشف عن بعد زمني ثالث: هو زمن الكتابة، زمن إدراك لاحق لما لم يُفهم في حينه. هذا التداخل بين التبئيرات، كما يحلّله جنيت، يُعمِّقُ وحدة السرد، لأن ما يُروى من داخل الطفلة يُؤطَّر ضمن رؤية أكثر وعيًا تسمح بقراءة التجربة من موقع مركّب يتسع للسؤال والتفسير، ولا يكتفي بالوصف أو التسجيل.
تأتي اللغة في هذا السياق، بوصفها الوعاء المشترك بين البنية والزمن والهوية، متقشفة لكنها مشحونة بالإيحاء، فهي لا تصف العالم ولعلها توشوشه، فهي لا تشرح ولا توضح، وتكتفي بالتلميح؛ وهي بذلك تُمارس وظيفة مزدوجة: تُعيد تمثيل العالم الريفي بما فيه من بساطة وخشونة وعاطفة، وتُضفي على ذلك العالم بعدًا داخليًا يجعل كل مشهد – مهما كان هامشيًا – لحظة وعي. وهنا يتجلّى دور السرد بوصفه أداة إدراك لا مجرد حكاية، وهو ما يؤكده ريكور حين يعتبر السرد نمطًا لفهم الذات أكثر من كونه إعادة سرد لتجربة خارجية.
إن يوميات مريم هي رواية عن طفلة في قرية، وسردية متشظّية لهوية تتكوّن عبر تشظي المكان والزمان والصوت، وتعيد تشكيل نفسها في مواجهة الفقد، والغياب، فتقف الرواية عند تقاطع دقيق بين الحميمي والرمزي، بين البنية الدقيقة للزمن السردي والانفعال الوجودي للذات، وبين التشخيص الخارجي لمظاهر الحياة القروية، والغوص الداخلي في معاني التكوين الأنثوي. بهذا المعنى، تتجاوز الرواية حدود الأجناس الأدبية لتكتب نفسها كوثيقة سردية للذات، ومختبرًا لتجربة الحكي بوصفه مشروعًا وجوديًا تأويليًا.